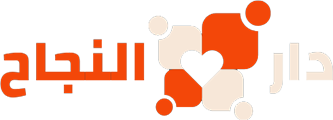هل نحن بحاجة إلى تصوف؟ سؤال محير إلى أبعد حد، وذلك لعدم وروده في الشريعة قرآنا وسنة هذا أولاً، وثانياً- لأن التصوف كمدرسة إسلامية في الشريعة، يوحي بأن الإسلام العام في ذاته لا يكفي الإنسان المسلم، بينما نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه الأعرابي فيسأله عن الإسلام، فيبين له أركانه الخمسة، فيقول الأعرابي: لا أزيد ولا أستزيد، فيقول صلى الله عليه وسلم: " أفلح إن صدق ". والصحابة جميعاً رضي الله عنهم لم يعرفوا التصوف ولا ابتدعوه، ولم يتميز أحد منهم به، مع كل الدعاوي التي تتمحل نسبته إلى بعضهم، من غير دليل أو برهان واضح، مع أن كثيراً من الصحابة تميز بالفقه والاجتهاد وفهم الأحكام، وهذا مشهور معروف مدون، أما أن الحاجة إليه نشأت فيما بعد، عندما انغمس المسلمون في الدنيا ومتاعها، فهذا صحيح إلى حد ما، لكن من قال أن الحاجة كانت إلى هذا اللون من السلوك المتميز عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ " روى البخاري (2652) ، ومسلم (2533) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه، لماذا لم تنشأ مع مدارس الفقهاء، مدارس وعاظ ودعاة على غرار مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، إحياءً لما اندرس من الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا، والاستمرار في إحياء روح تقوى الصحابة وإخلاصهم رضي الله عنهم؟ ليبقى الإسلام هو الإسلام، لا زيادة فيه ولا نقصان، سؤال مطروح يحتاج إلى إجابة جريئة وصراحة لا لبس فيها ولا غبش، لئلا نغير سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل أصحابه بأفواهنا وخيالاتنا وتمحلاتنا التي ما أنزل الله بها من سلطان. تساؤلاتي هذه لا تعني أن كل ما جاء به المتصوفة خطأ في خطأ، أبداً، خاصة أن الحضارة الإسلامية استوعبت حضارات الأمم قاطبة، التي دخل أبناؤها في الإسلام، والذين لم يدخلوه، وأنتج ما أنتج في كل مناحي الحياة، لكن هذا الإنتاج في معظمه دنيا ومدنية قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنتم أعلم بدنياكم": ومن ذلك علوم الفلك والرياضيات والهندسة والجبر والحساب والجغرافيا والفيزياء والكيمياء والطب....الخ، وهذا لا يقال فيه بدعة ولا ابتداع. لكن البدعة والابتداع في الدين ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه، والتصوف كعلم ينسب للدين وليس للدنيا، يؤصل للسلوك الإسلامي الحنيف، يفترض فيه أن لا يخرج عن الأساليب والمفاهيم والوسائل التي شرعها القرآن، وطبقها الرسول صلى الله عليه وسلم، والتزم بها صحابته الكرام جميعاً، دون أن يعرف فيهم من أسس لحزب أو جماعة أو مدرسة، يمكن أن تكون دليلاً وبرهاناً للصوفية والتصوف، الذي نشأ في فترات تراجع الأمة عن وحدتها وقوتها وكلمتها الجامعة، وليس هذا فحسب، بل نشأت في نفس الظروف أيضاً مدارس سياسية انشقت عن الأمة ووحدتها، تحت شعارات ومبررات لا تقل خطورة عن ذلك، مثل: السبأية والعلوية والقدرية والخوارج، وغيرهم كثير، كلما ابتعد الناس عن النبع الأصيل والألى من الرعيل الأول أبدع كثير من الصوفية في تحليل السلوك الإنساني والنفسي والتعبدي، ووصل كثير منهم إلى مراقي في هذا التحليل، نتيجة للمجاهدات في التعبد والتحنث، والتعبير عنها بأدب رفيع وشعر بليغ ونثر جميل، لكن هذا كله اختلط لدى كثير من هؤلاء – إلا ما رحم ربي – اختلاط الحابل بالنابل، أخذا من كتب الفلاسفة ومفكري الأديان السماوية والأرضية، حتى أصبح التصوف كما وصفه أحدهم بأنه الدين الرابع، بعد اليهودية والمسيحية والإسلام، بل ربما هناك من يعرفه بأنه الدين العالمي الذي يحتوي ويستوعب جميع الملل والنحل، وهذا ليس دعوى فيها شطط أو جحود، بل هو الواقع الذي مرت به مدارس التصوف عبر التاريخ القديم والحديث، وكتبهم ومواقف كثير من أتباعهم تدل على ما نحذره ونقوله فيهم من افواههم وسلوكياتهم، صحيح أن عامة المريدين من أتباعهم لا يخوضون في هذه المخاضات الفكرية والسلوكية الخطرة، لأنهم يكتفون من شيوخهم بالظواهر وما يوافق شرع الله فحسب، لكن المتعمق في طريقة تربية هؤلاء الاتكالية والتسليمية والفردية، التي تحرم الإسلام التطبيقي والمسلمين عموماً من شعور هؤلاء بالجماعة المسلمة ومسؤولياتهم تجاهها في الدفاع عن دولة الإسلام التي أقامها رسول الله والخلفاء الراشدين من بعده، وتحولها في أذهانهم إلى دنيا للملوك والأمراء لا شأن لهم بها ولا بهم. فانزوى الصوفية ومعهم عامة المسلمين، في خدمة أوليائهم الصالحين، وليس في خدمة الإسلام والمسلمين، إلا من رحم ربي، حتى أن مريدي المدارس الصوفية وأوليائها كانوا في أوج نشاطاتهم وعزهم، بينما بغداد تسقط في يد المغول، وأتباع جنكيز خان، والعالم الإسلامي ينقسم إلى شراذم دول ودويلات، والصليبين يحتلون الديار المقدسة، والصوفية لا هم لهم سوى إرضاء ولي الله والقطب والبدل والشيخ والشيخة، والانكفاء على إصلاح النفس بطرق ووسائل لا تزيد المسلم علماً، ولا ترفع أو تزيل عنه جهلاً، بينما الأمة تؤكل من أطرافها وقلبها ولبها. كثير من الفلاسفة والحكماء وأرسطو وأفلاطون دعوا إلى الفضيلة والقيم الأخلاقية، فهل نقول عنهم أنهم من أهل الله وأنهم أولياء الله ؟! وكذلك كثير من الرهبان والأحبار والكهان في شتى بقاع الأرض دعوا إلى الأخلاق والتأمل وعبادة الله، في الصوامع والكهوف والمعابد، فهل نقول: أنهم اولياء الله وخاصته؟! وكثير من المسلمين عبدوا الله بصدق وأمية واخلاص في البوادي والأرياف والجبال، فهل نقول عنهم أنهم أقطاب وأبدال وأولياء ؟! إذا كان كل ذلك جوابه بالنفي، فلماذا نخص من لم يخصصهم قرآناً ولا سنة، بشيء لا يعيد مجد أمتنا ولا دولة رسولنا، ولا يوحد كلمتنا، ولا يزيل جهالتنا، ولا يحل مشاكلنا، التي وصلت حد وضع السكين على رقاب أبنائنا وأطفالنا ونسائنا، ونحن نزعم أن فينا أولياء الله الذين لا يعدون على أصابع اليد الواحدة أو اليدين، وهم مخفيون في دهاليز التكايا وجحور الجبال، أو ما هو مثلها، لا سلطان لهم على شعب ولا على امة، ولا سدوا مسد ما فعله نور الدين زنكي أو صلاح الدين الأيوبي أو العز بن عبد السلام، أو أمثال هؤلاء من العلماء والمجاهدين والأمراء الصالحين، ولو رحنا نحلل وندرس كتب هؤلاء القوم، فسنجد العجب العجاب، من الأغاليط والأوهام، التي لا يضبطها ضابط من شرع أو دين، ولا قاعدة من قواعد الفقه والعقل والمنطق، بالإضافة إلى منقولات عن فلاسفة كانوا قبل المسيح أو بعده، وفي كثير منها شرك أو حلول أو كفر بواح، لا تقبله شريعة أو دين، ومع ذلك ندعى إلى تبريره وتأوله وتمحل تفسيره، بما يجعله مسكوتاً عنه أو مقبولاً، مع أن قليل البضاعة من الإسلام وعلومه؛ يعلم أن الحديث الموضوع لا يقبل في شرع الله، والحديث الضعيف لا يقبل في العقيدة والأحكام، فكيف يقبل لقياد النفس إلى عبودية الله والإخلاص مثل هذا وأمثاله؟! ما الحل إذاً؟ الحل بأن نجتهد في الإسلام كله، لإعادة إحياء ما اندثر من معالمه، بكتابة السيرة كما طبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم، ونعيد فتح باب الاجتهاد لمن توفرت فيه شروطه، ونؤسس مدارس وجامعات على أعلى مستوى لهذه الأغراض، ونمحص من التصوف ما كان نافعاً، له سند من قرآن أو سنة، فننحيه عن الكتب التي جمعت الحابل والنابل، ونبرزه للأمة دون تمزيقها بين طرق كثيرة ليس الغرض منها سوى التبعية والتعيش من الصلاح والتقوى، مع أن الصالح التقي لا يأكل إلا من عمل يده، كما أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونخلط هذا بالفقه كأحد فصوله وأبوابه، لنجعله في رعايته وضوابطه، ونجدد فيه كما نجدد في الفقه والتشريع، والأصول والتفسير، واللغة والأدب. وذلك لئلا يتصيد من أراد التصيد، في الأوقات الحرجة والأحوال المنكرة، يمزق الأمة أو يتزعم عليها وفيها؛ من غير مؤهلات علمية، أو وظائف مشروعة، أو خدمة مقننة، تحت طائلة الحساب والمحاسبة، كما يُفعل مع الجمعيات الخيرية المرخصة، من خلال تحديد المهام والمجال وميزانية الإيداع والسحب، وبإشراف لجان مختصة فيها من كل التخصصات اللازمة لمثل هذه المشاريع الإصلاحية في الدولة الإسلامية، وإلا لن تقوم لنا قائمة ونحن نخبط خبط عشواء، ذات اليمين وذات الشمال، تحت كل الدعاوى الصالحة والطالحة، ولا منجاة لنا إلا بالعودة الجادة إلى الراشدية، والعمرية، والصلاحية، بمنطق عصرنا الذي نحن فيه، مع أصالتنا التي لا نتخلى عنها تحت أي ظرف من الظروف، وآخر دعوانا أن لا مشتكى إلا لله، ولا حمد إلا إليه، سبحانه العلي العظيم.
بقلم: محمد نبيل كاظم.